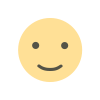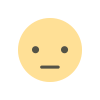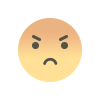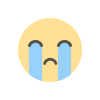علم النفس ليس ترفًا: ماذا يعني أن تدرس علم النفس؟
تحليل علمي وفلسفي لعلم النفس من جذوره النظرية إلى تطبيقاته المعاصرة، يسلط الضوء على الأمراض النفسية، التخصص الأكاديمي، العلاج النفسي، وتحليل العوامل الثقافية التي تشكل فهمنا للذات في السياق العربي. رحلة في عمق الإنسان وأسئلته الكبرى.

في عمق كل حضارة هناك علمٌ يعبّر عن علاقتها بذاتها، وموقع "علم النفس" من المجتمع هو مرآة دقيقة لنمط تفكير الإنسان حول ذاته وحدود فهمه لداخله. ففي المجتمعات التي تُقدّس الاستقرار السطحي وتُخفي التوتر تحت مظاهر الانضباط الاجتماعي، يصبح علم النفس إما ترفًا نخبويًا، أو وصمة ترتبط بالاضطراب والضعف. أما حين يُعاد الاعتبار لهذا العلم بوصفه أداة كشفٍ لا كتمان، وتأمل لا تصنيف، فإنه يتحوّل إلى رؤية وجودية للإنسان لا مجرد اختصاص أكاديمي.
يأتي هذا المقال ليعيد فتح ملف النفس، لا بوصفها بنية عصبية فقط، بل ككائن متداخل بين التاريخ، والثقافة، والذاكرة. نبدأ من الجذور: كيف نشأ علم النفس؟ ولماذا انفصل عن الفلسفة وتحوّل إلى علم؟ ثم نمر عبر محطات الأمراض النفسية التي لا تعكس فقط اضطرابًا داخليًا بل أحيانًا احتجاجًا على واقع خارجي مضطرب.
ثم نتساءل عن موقع التخصص الأكاديمي في هذا العلم: هل يتم تلقينه كحزمة مصطلحات؟ أم يُدرَّس كرسالة لزراعة البصيرة؟ ونصل في النهاية إلى غرف العلاج النفسي، لنفكك هذا الفضاء الذي أصبح في بعض التجارب متنفسًا وفي تجارب أخرى تجارة خادعة. ثم نرتفع بالسؤال إلى السياق العربي: لماذا تتأخر مجتمعاتنا في احتضان مفهوم الصحة النفسية؟ هل نحن أمام أزمة وعي فردي، أم أننا في مواجهة بنية ثقافية تصم المعاناة وتكافئ الإنكار؟ هذا المقال ليس مديحًا لعلم النفس، بل دعوة لتحريره من القيود الأكاديمية الصماء ومن التشويه التجاري، ليستعيد مكانته كعلم يسائل الإنسان، لا يصنّفه.
جذور علم النفس: بين الرغبة في الفهم ومقاومة الجهل
في كل حضارة حاول الإنسان أن يجيب على سؤالٍ قديم جديد: "من أنا؟"
سؤال لا يختزل في الهوية البيولوجية ولا يُختصر في الانتماء الثقافي، بل يتجذر في أعماق الوعي البشري، حيث تتقاطع الرغبة في الفهم مع رهبة الاكتشاف. ولعل نشأة علم النفس تمثل أحد أكثر تجليات هذا السؤال جرأةً وتعقيدًا، إذ انتقل الإنسان من تفسير سلوكه ومشاعره عبر الخرافة أو الدين أو الأدب إلى محاولة تفسيرها بمنهجية علمية يمكن تكرارها، نقدها، والاعتماد عليها.
التحول المعرفي
لم يكن ميلاد "علم النفس" حدثًا فجائيًا. بل هو ثمرة قرون من التأملات الفلسفية واللاهوتية التي لم تكن تُفصل بين النفس والعالم أو بين الداخل والخارج. غير أن اللحظة الفارقة كانت مع انتقال هذه التأملات إلى حقل الاختبار التجريبي، كما حدث في أواخر القرن التاسع عشر مع ويلهلم فونت الذي أسس أول مختبر نفسي في لايبزغ عام 1879، مُعلنًا بذلك بداية تخصص علم النفس كعلم مستقل عن الفلسفة والطب. وهنا بدأت تتبلور الإشكالية الأساسية: هل يمكن دراسة النفس كأنها ظاهرة مادية؟ هل يمكن عزل الشعور، والذاكرة، والإرادة، ووضعها تحت المجهر؟
تاريخ علم النفس
قبل ويلهلم فونت، كانت معالجة النفس حكرًا على الفلاسفة ورجال الدين. أفلاطون وأرسطو قدّما أولى الإسهامات الفلسفية في فهم النفس، حيث رأى أفلاطون أن النفس تنقسم إلى ثلاثة أجزاء: عقل، وشهوة، وغضب، في حين صاغ أرسطو فكرة النفس كقوة حيوية ترتبط بالجسد. وفي السياق الإسلامي، برزت أعمال الفارابي وابن سينا والغزالي التي تناولت النفس من زوايا أخلاقية وميتافيزيقية، وكانت لبِنات مبكرة في تشكيل علم النفس كأداة للتزكية والفهم معًا.
لكن التأسيس العلمي الحديث بدأ مع فونت، وتبعه ويليام جيمس في الولايات المتحدة الذي أسّس مدرسة "الوظيفية"، معتبرًا أن العمليات النفسية يجب دراستها بوصفها أدوات للتكيف مع البيئة. ثم جاء سيغموند فرويد ليقلب الطاولة، بتأسيسه مدرسة "التحليل النفسي"، التي وضعت اللاوعي في مركز الفهم النفسي، معتبرًا أن صراعات الطفولة والدوافع الجنسية اللاواعية هي منبع السلوك البشري. لاحقًا، عارض جون واطسون هذا النهج ممهّدًا للمدرسة السلوكية التي لا تعترف إلا بما هو قابل للملاحظة والقياس، وهو توجه تبناه لاحقًا ب. ف. سكنر.
غير أن منتصف القرن العشرين شهد عودة للبعد الإنساني مع كارل روجرز وإبراهام ماسلو، اللذَين أسسا "علم النفس الإنساني"، مؤكدين على الحاجة لفهم الإنسان ككائن يسعى نحو تحقيق ذاته. ثم برز علم النفس المعرفي على يد جان بياجيه وألبرت بندورا وآخرين، ليعيدوا الاعتبار لعمليات التفكير، والتعلم، والإدراك، كعناصر مركزية في فهم السلوك. وفي العقود الأخيرة، شهدنا انبثاق "علم النفس الإيجابي" عبر مارتن سيليغمان، ومحاولات لتوسيع نطاق العلاج النفسي ليشمل مفاهيم مثل الامتنان، المعنى، والمرونة النفسية.
صعود المنهج التجريبي
مع اتساع تخصص علم النفس، برز تيار جديد حاول فصل النفس عن اللاوعي الغامض والرمزي، وهو التيار السلوكي، الذي اعتبر أن لا فائدة من دراسة ما لا يمكن ملاحظته. فجاءت مدارس مثل البافلوفية والاسكنيرية، التي اختزلت السلوك الإنساني إلى مثيرات واستجابات قابلة للتكرار. لكن سرعان ما أظهر هذا التبسيط عجزه عن تفسير المعقد من التصرفات، فبدأت العودة التدريجية إلى دراسة العمليات المعرفية واللاشعورية، فصعدت مدراس "العلاج المعرفي السلوكي" و"التحليل النفسي" و"العلاج الإنساني".
الأمراض النفسية
إذا كان "علم النفس" قد نشأ من الرغبة في الفهم، فإن "الطب النفسي" و"العلاج النفسي" نشآ من الحاجة إلى التخفيف. فحين عجز العقل عن تفسير آلام النفس، بدأ يسميها. وحين عجز عن كبحها، بدأ يعالجها. وهكذا، تشكل مفهوم "المرض النفسي" في مفترق طرق بين العلم، والمجتمع، والسلطة، واللغة.
في العصور القديمة، كانت المعاناة النفسية تُفسَّر بوصفها مسًّا من الأرواح أو غضبًا إلهيًا. وبهذا التفسير الماورائي، نشأت أولى محاولات العزل والإقصاء، حيث بُنيت المصحات كأماكن يُخفي فيها المجتمع ما لا يريد أن يراه، لا كأماكن شفاء أو فهم. لكن مع التنوير، بدأت إعادة النظر في ماهية الجنون. وأصبح "المرض النفسي" شيئًا قابلاً للتصنيف والقياس، بفضل ظهور الطب العقلي في أوروبا. ومع تطور أدوات التشخيص (كالـ DSM وICD)، انتقلنا من الخطابات اللاهوتية إلى جداول الأعراض والتصنيفات الدقيقة. وهكذا نشأ فرع مستقل: "طب نفسي"، يرتكز على التفسير البيولوجي للاضطرابات، ويربط الخلل النفسي بعدم توازن كيميائي أو خلل عصبي.
هل المرض النفسي مشكلة فردية فقط؟
غير أن كثيرًا من المفكرين والفلاسفة والممارسين انتبهوا سريعًا إلى محدودية الرؤية الطبية البحتة. فليس كل ألم نفسي خللاً كيميائيًا، وليس كل اضطراب قابلًا للدواء. من هنا، صعدت المدارس النفسية التي ترى في الاضطراب النفسي استجابة للواقع لا خللاً في الجهاز العصبي فقط. فالاكتئاب قد يكون صرخة وجودية، لا اضطراب سيروتونين. والقلق قد يكون رد فعل عقل نقي يرى فوضى العالم ولا يعرف كيف يصمت. الأمراض النفسية، في هذه الرؤية، ليست أعطالاً ميكانيكية بل لغة معطلة، تحاول بها النفس أن تقول شيئًا لم تعد تعرف كيف تقوله.
الطب النفسي والعلاج النفسي هل هم وجهان لعملة واحدة أم ممارستان متنافرتان؟
يخلط كثيرون بين "الطب النفسي" و"العلاج النفسي". لكن الأول يتعامل مع النفس عبر الجسد، بينما الثاني يتعامل مع النفس عبر المعنى. الطبيب النفسي قد يصف مضادات اكتئاب لمريض فقد شغفه بالحياة. أما المعالج النفسي، فقد يدعو هذا المريض للحديث عن والدته، أو طفولته، أو غياب القيمة في عمله. وقد أثبتت التجربة أن الدمج بين المدرستين هو الأكثر فعالية في بعض الحالات، خاصة حين يمتزج العلاج الدوائي بفهم عميق لجذور المعاناة. لكن يبقى هناك سؤال مفتوح: هل كل اضطراب يحتاج إلى علاج؟ أم أن بعض المعاناة ضرورية لتشكّل وعينا ونضجنا؟
أمراض أم أعراض؟
تُصنّف منظمة الصحة العالمية عشرات الحالات كـ "أمراض نفسية": الاكتئاب، اضطرابات القلق، الوسواس القهري، اضطراب ما بعد الصدمة، الفصام، الاضطرابات ثنائية القطب وغيرها. لكن هذا التصنيف، وإن كان ضروريًا للأطباء وشركات الأدوية، يثير أسئلة فلسفية وأخلاقية:
- هل نقوم بتطبيب الوجود الإنساني؟ هل نحاول تخدير الحساسية الزائدة بدل الاستماع لرسالتها؟
- وهل كل من يشعر بانعدام المعنى، مكتئب؟
- أم أن المجتمعات الحديثة عاجزة عن احتضان الفرد، فتجعله "مريضًا" لتُسكت احتجاجه؟
إذا كان الجسم يمرض حين يختل توازنه الداخلي، فإن النفس تمرض حين يختل توازنها الوجودي. ولذلك فإن الأمراض النفسية ليست فقط خللاً بل مرآة: مرآة لما نكتمه، وما نتجاهله، وما لا نقوله. إنها جرس إنذار لا يجب كتمه بالأدوية فقط، بل يجب الإصغاء له بأسئلة أعمق: من نحن؟ ولماذا نتألم؟ وما الذي فقدناه في مسيرة النمو حتى صرنا بحاجة إلى دواء كي ننام؟
تخصص علم النفس بين إغراء الأكاديميا وتحديات الفهم العميق
أن تختار دراسة "علم النفس" لا يعني بالضرورة أنك اخترت أن تفهم النفس. فما أكثر من يدرسون هذا التخصص طمعًا في وظيفة، أو بريق أكاديمي، أو لأنهم "يحبون مساعدة الناس"، دون أن يدركوا أن أول نفس تحتاج إلى المساعدة هي النفس التي بداخلهم.
الجامعات تفتح أبوابها لمن يود دراسة تخصص علم النفس، لكنها لا تخبرهم أن هذا العلم يتطلب شجاعة مواجهة الذات قبل القدرة على تحليل الآخرين. فهو ليس كعلم الأحياء أو الاقتصاد أو الهندسة. إنه علم يدخل في عصب الإنسان العاري، يتطلب من دارسه ألا يحفظ فقط، بل أن يعيد التفكير في مفاهيم مثل: الهوية، الإرادة، الطفولة، الألم، الخوف، وحتى الحب. ولذلك، فإن التحدي في هذا التخصص لا يكمن في اجتياز الاختبارات، بل في إعادة هيكلة الذات لتكون قادرة على الفهم لا على التفسير السطحي.
في كثير من الجامعات، يُقدَّم علم النفس في صورته الأكثر اختزالًا: معلومات نظرية، نماذج مدرسية، ومصطلحات متخصصة، دون تعميق في جوهر الإنسان. والأخطر من ذلك، هو تحويل العلم إلى أداة سريعة للتصنيف: هذا مكتئب، وتلك مصابة بقلق اجتماعي، وذاك يعاني اضطرابًا في الشخصية... كما لو كانت النفس معادلة رياضية نُدخل فيها الأعراض فتخرج لنا النتيجة. بهذا الأسلوب، يتحول علم النفس من حقل للفهم والتحوّل إلى أداة تشخيصية باردة تفصل بين الذات وماضيها، بين الألم وسياقه، بين الفرد ومعناه.
كثير من خريجي تخصص علم النفس يدخلون المجال بشغف كبير، لكنه غالبًا ما يصطدم بالواقع البيروقراطي: فرص وظيفية محدودة، أنظمة ترخيص صارمة، وأحيانًا نظرة مجتمعية غير ناضجة تعتبر المشتغل بالنفس كمن يعبث في المجهول أو يتطفل على الخصوصيات. ومع اتساع الاهتمام بالصحة النفسية، ظهرت أيضًا موجة من الممارسين غير المؤهلين، مما ساهم في تشويه صورة التخصص وإفراغه من هيبته العلمية.
ما الذي يجب أن يُدرَّس حقًا في تخصص علم النفس؟
بعيدًا عن التنظير، هناك مواد ومهارات يجب أن تكون جزءًا جوهريًا من التكوين الأكاديمي لطالب علم النفس:
-
الفلسفة والأنثروبولوجيا: لفهم النفس كنتاج لثقافات وتجارب تاريخية لا ككائن بيولوجي معزول.
-
مهارات الإصغاء والتحليل العميق: لأن كل جلسة نفسية ناجحة تبدأ بإصغاء صادق.
-
أخلاقيات المهنة: لأن اللعب بأعماق الناس دون أخلاق هو عبث خطير.
-
خبرة ذاتية: أي خضوع الطالب نفسه لجلسات إشراف أو تحليل نفسي كشرط للتمكين من فهم الآخرين.
العلاج النفسي
إن "العلاج النفسي" في جوهره ليس طقسًا علاجيًا يُمارَس على النفس، بل هو فعل مشترك بين معالج ومراجع، يتطلب بيئة من الثقة والإفصاح والقبول غير المشروط. هو عملية تكشف الطبقات اللاواعية، وتعيد ترتيب السرديات التي يبني الإنسان بها نفسه. أي أنه ليس حلًّا، بل كشفًا؛ ليس وصفة، بل مرآة. بينما يسعى الطب النفسي إلى تهدئة العَرَض عبر التدخل الدوائي، يعمل العلاج النفسي على إعادة بناء المعنى الذي تحوّل إلى ألم.
الإشكالية الأخلاقية في العلاج السطحي
كثير من الممارسات السائدة اليوم تقدم جلسات علاجية بوصفها متنفسًا للكلام أو تفريغًا للضغوط، دون رؤية تحليلية للسرد النفسي العميق. هذا النوع من "العلاج الترفيهي" قد يمنح شعورًا مؤقتًا بالراحة، لكنه لا يُحدث تحوّلًا بنيويًا في فهم الذات. والأخطر من ذلك أن بعض المعالجين يرسّخون علاقات اعتمادية، بدلًا من تمكين المراجع من بناء استقلاليته النفسية. فيتحوّل العلاج إلى حاجة، لا إلى وسيلة للخروج من الحاجة.
في تخصص يتعامل مع جوهر الإنسان، لا تكفي الشهادات أو الدورات التدريبية لصناعة معالج نفسي حقيقي. المعالج الجيد ليس من يعرف المصطلحات، بل من يعرف كيف يصغي دون حكم، ويحمل ألم الآخر دون امتصاص، ويقود النفس نحو النضج لا الطمأنينة الزائفة. إن القدرة على تحمل صمت المراجع، أو مقاومته، أو إسقاطاته، هي مهارة لا تُدرَّس في القاعات. بل تُكتسب بتواضع معرفي، وبإخضاع الذات للتحليل، وبخوض المعالج نفسه لمسارات تشافٍ قبل أن يتصدّر قيادة الآخرين.
التوجهات الجديدة
في العقود الأخيرة، بدأنا نشهد تحولات مهمة في مفهوم العلاج النفسي:
-
ظهرت نماذج تدمج بين العلاج النفسي والتحليل الثقافي، مثل "التحليل السردي" و"العلاج عبر الهوية".
-
وانتشر مفهوم العلاج الجماعي و"العلاج بالكتابة" و"العلاج بالفن"، كتوسيع لمساحات التعبير.
-
كما بدأ بعض المعالجين يعيدون النظر في العلاقة بين الصحة النفسية والبنية الاجتماعية، فبدؤوا يسألون: هل من المنطقي علاج الاكتئاب لدى فرد يعيش في بيئة تكرّس القهر والاغتراب؟
"العلاج النفسي" ليس وعدًا بالشفاء، بل وعد بالحقيقة. إنه كشف ما خُفي، ونبش ما ترسّب، وإعادة الاتصال بجوانب النفس التي نُفيت طويلًا. وهو في ذلك، لا يسير في خط مستقيم. بل قد تكون الجلسة المؤلمة أكثر فائدة من تلك التي ينتهي فيها المراجع بابتسامة. فالعلاج الحقيقي لا يُقاس بعدد الجلسات، بل بمقدار ما تغيّرت رؤيتك لنفسك وللعالم بعد خوضه.
المجتمعات العربية والصحة النفسية
إذا كانت النفس الإنسانية بطبيعتها معقدة، فإن النفس العربية تعاني تعقيدًا مضاعفًا، لأنها لا تنشأ فقط في فضاء داخلي، بل تتشكل ضمن نسيج اجتماعي يخلط بين الأخلاق والتقاليد والدين والسيطرة، ويختزل الصحة النفسية في ثنائية العيب والجنون.
لا يزال كثير من الناس في العالم العربي يترددون في اللجوء إلى العلاج النفسي خشيةً من "الكلام"، لا لأنهم لا يتألمون، بل لأن المجتمع حولهم لا يعترف بالألم النفسي كألمٍ مشروع. من يذهب إلى طبيب نفسي يُتهم غالبًا بأنه ضعيف، أو مضطرب، أو "مجنون"، فتتكوّن حوله هالة من الشك أو الشفقة، كأن اعترافه بمرض نفسي هو إعلان عن فشله في السيطرة على ذاته. وهنا تنشأ الوصمة، لا كقرار فردي بل كصناعة مجتمعية، تُجرِّم المعاناة بدلاً من أن تفهمها، وتكافئ الإنكار بدلاً من الصراحة.
حين يُدرّس الطفل العربي علوم الحياة، والفيزياء، والدين، ولا يُعرَّف بماهية العواطف أو معنى القلق أو آليات الدفاع النفسي، فإننا نُنشئ أجيالاً تعرف قوانين نيوتن أكثر مما تعرف قوانين ذاتها. إن غياب الخطاب النفسي من المناهج التعليمية لا يعكس فقط تقصيرًا أكاديميًا، بل فقرًا في الفهم الجمعي لطبيعة الإنسان. فلا يكفي تعليم الناس كيف يفكرون، بل يجب أن نعلمهم أيضًا كيف يشعرون، ومتى يتحدثون، وكيف يتعاملون مع الخوف، والخسارة، والخذلان.
دور الدين والتقاليد في إعادة توجيه المعاناة
غالبًا ما يُعاد توجيه الألم النفسي في الثقافة العربية عبر قنوات دينية أو اجتماعية: "اقرأ القرآن وسترتاح"، "توكّل على الله"، "كلنا مررنا بهذا"، "تزوج وتنسى"، وغيرها من الوصفات الجاهزة التي تُستخدم أحيانًا كعازل أمام الاعتراف بالمشكلة. وهنا لا يكون الدين في حد ذاته هو المانع، بل طريقة استخدامه كوسيلة للتقليل من شأن الألم وتحويله إلى مجرد نقص في الإيمان أو ضعف في الإرادة.
الإعلام والمنصات النفسية
مع صعود وسائل التواصل، انتشرت الحسابات النفسية، لكن كثيرًا منها يقدم معلومات سطحية أو تجارية، فتنتشر مفاهيم مثل "الحدود النفسية" و"الطاقة السلبية" و"الهالة الشخصية" بطريقة لا علاقة لها بالعلوم النفسية الرصينة. وهكذا تتأرجح النفس العربية بين تجاهل رسمي وتبسيط شعبي، وبين من يُحرم العلاج ومن يُفرغه من مضمونه.
الواقع أن المشكلة ليست في الأفراد الذين لا يطلبون المساعدة، بل في منظومة الوعي التي تجعل من طلب المساعدة فعلًا مُحرّجًا. نحن أمام خلل في البنية الثقافية التي لا تفصل بين المعاناة الأخلاقية والمعاناة النفسية، والتي ترى في كل حزن تهديدًا، وفي كل قلق ضعفًا، وفي كل اكتئاب وصمة.
إن السعادة ليست في كبت الألم، بل في تعلّم كيف نحمله دون أن يُكسِرنا. ولا سبيل لذلك إلا بوعيٍ أعمق بالنفس، بمظلمتها، وتاريخها، وصراعاتها، وقوتها. ليس هذا المقال دراسة أكاديمية باردة، ولا تأملًا تجريديًا منزوع السياق، بل محاولة جادة للربط بين العلم والسؤال، بين التشخيص والكرامة، بين الذات وسياقها الثقافي.
لقد حاولنا أن نُحرّر علم النفس من قبضة الاستسهال الشعبي ومن الانغلاق المهني، ليعود كما بدأ: علمًا يستنطق الإنسان، لا يصنّفه؛ علمًا يعالج بالبصيرة، لا بالوصمة. في زمن مضطرب، تظل الصحة النفسية هي معركة الكرامة الأخيرة، وهي لا تُخاض بالإنكار ولا بالتجريب العشوائي، بل بفهم حقيقي للإنسان بوصفه بنية نفسية–ثقافية–تاريخية معقدة.